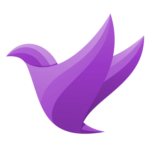في إحدى الجلسات، طرح أحد الحاضرين سؤالًا طريفًا على جحا قائلًا: “كم يبلغ عدد الشعرات في رأسك يا جحا؟” فرد جحا بسرعة وبدون تردد: “العدد هو واحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسع وستون شعرة.” وبدهشة، سأله الجليس: “وكيف توصلت إلى هذا العدد بالضبط؟” فأجابه جحا بمكر: “إن كنت لا تصدقني، فعليك أنت بنفسك أن تقوم بعدها!”
لا يشكل جهل الجليس بعدد شعرات جحا والصعوبة البالغة في حصرها دليلاً على صحة العدد المذكور، وهو ٥١٣٦٩ شعرة! يستخدم جحا هنا استراتيجية ذكية حيث يُعلن عن رقمٍ معين ويُثبت قضية بطريقة استباقية، وبذلك يُسقط على الجليس “عبء البرهان” بشكل غير عادل، مما يضطر الجليس لأن يبذل جهدًا نيابة عنه. هذه التقنية تُظهر مغالطة “الاستناد إلى الجهل”، والتي تعني أنه ما لم يُثبت العكس، فإن الأمر يُعتبر صحيحًا، والعكس صحيح أيضًا؛ حيث يُعتبر أي شيء خاطئًا إذا لم يُثبت صحته بدليل. وفي كلا الحالتين، يُفسر غياب الدليل على أنه دليل على البطلان أو يُستخدم للدفاع عن صحة دعوى ما إذا لم يتمكن الخصم من دحضها. إن الجهل مجرد جهل، وليس دليلاً على صحة أو خطأ أي شيء سوى على حقيقة أننا نجهل.
فخ الوقوع في مغالطة خلطت الأمور في البلاد!
كما يقول المثل الفرنسي، الاعتذار في حد ذاته اتهام.
من أبرز الأمثلة على مغالطة الاحتكام إلى الجهل هي التحقيقات التي أجراها السيناتور جوزيف مكارثي في الخمسينيات من القرن العشرين. خلال سلسلة من جلسات الاستماع المُذاعة، وجه مكارثي اتهامات الانتماء للشيوعية للعديد من الأبرياء. هذه الاتهامات، التي تذكرنا بحملات مطاردة الساحرات في العصور الوسطى، لم تكن مبنية على أدلة ملموسة وكانت تضر الكثيرين بشكل بالغ. في تلك الجلسات، كان مكارثي يظهر وهو يحمل حقيبة ممتلئة بالملفات المتعلقة بالمتهمين، لكنه نادراً ما قدم برهاناً قاطعاً، وغالباً ما كان الشخص يُتهم بناءً على عدم وجود ما يدحض اتهاماته الشيوعية في ملفات مكارثي! خلال اجتماع في مجلس الشيوخ عام ١٩٥٠، أقر مكارثي بقوله: «ليس لدي معلومات كافية في هذا الأمر سوى ما ورد في تقرير عام من الوكالة يفيد بأنه لا توجد أدلة تُثبت عدم ارتباطه بجماعات شيوعية.»
في هذه المواقف، كان مكارثي يستغل مغالطة الاحتكام إلى الجهل: حيث يُحول “عبء البرهان”، بدلاً من أن يُثبت ادعاءه بالأدلة، يبني ادعاءه على عدم وجود أدلة تُنفي الادعاء، وهذا خطأ لأنه ينطلق من مبدأ أن الجهل بمعلومة ما يُؤدي إلى استنتاج مُسبق بأنه “عرف” أو “أثبت” أن الشخص مدان بالميول الشيوعية. الاتهامات التي يطلقها مكارثي خطيرة ويجب أن تحمل “عبء البرهان” ولا يجوز توجيهها لأي شخص مجرد لأنه لا يمتلك أدلة تدحضها. لنفترض أن أحد ضحايا مكارثي قرر مواجهة هذا الاتهام وبدأ بإثبات براءته من الميول الشيوعية بكل الطرق الممكنة، من خلال عرض جدوله اليومي، والمجموعات التي يلتقي بها، وأنشطته خلال العطلات، وأماكن تواجده المختلفة، لكن هذا سيعرضه لمزيد من التحقيقات والشبهات، ويجعله يبدو مذنباً بعيون الآخرين!
يحذر واتلي Whately من هذه الاستراتيجية الخطيرة في المناظرات ويقارنها بتصرف جيش يخرج من حصنه المنيع ليواجه عدوه في ميدان مفتوح، فيُهاجم من كل جانب ويُهزم شر هزيمة. في المناظرات، إذا فاتتك فرصة الاحتفاظ بموقفك الذي يتطلب من خصمك أن يحمل “عبء البرهان”، وبدلاً من ذلك بدأت بتقديم حجج إيجابية (قد تكون ضعيفة) لإثبات براءتك، فأنت بذلك تستبدل سلاحك الأقوى بآخر أضعف، يقول المثل الفرنسي «من يبرر أفعاله يدين نفسه!» qui s’excuse, s’accuse، مما يعني أنك تُظهر نفسك مذنباً في مواجهة الاتهامات الموجهة ضدك بتحميل نفسك عبء الدليل بدلاً من تحدي خصمك لإثبات اتهاماته بأدلة واضحة.
أمثلة أخرى:
- عدم وجود دليل على عدم وجود الأشباح يُستخدم كدليل على وجودها؛ ومن ثم يُفترض أن الأشباح حقيقية.
- أظن أن بعض الأفراد يمتلكون قدرات نفسية استثنائية. وما هي براهينك؟
- برهاني يقوم على أنه لم يثبت أحد بعد أن الأشخاص لا يملكون قوى نفسية استثنائية.
يجب أن نلاحظ هنا أن النقاش لا يدور حول إنكار وجود الأشباح أو القوى الخارقة بذاتها، بل حول بطلان الأساس المنطقي للحجج المُقدمة. الصعوبة الأساسية في هذه الأنواع من الحالات تكمن في تحديد ما يمكن أن يشكل دليلاً معتبراً على هذه الادعاءات أو ضدها، حيث يبرز تحدي خاص بالتحقق. في الواقع، لا تتوفر ملاحظات تجريبية مكررة تلبي معايير البيانة العلمية المطلوبة في هذه الحالات. هكذا، تحتوي الأمثلة التي تشير إلى الأشباح والقدرات الخارقة على عدد من الأخطاء المنطقية، ولعل أبرزها “الاستناد إلى الجهل”، حيث تستغل الحجج غياب الأدلة المضادة للقفز إلى استنتاجات واسعة لا تستند إلى ذلك النوع من الأدلة اللازمة لقبول مثل هذه النتائج.
متى تكون الحجة المستفادة من الجهل غير مغالطة؟
- هناك أوقات يكون فيها الاستناد إلى عدم المعرفة مبررًا تمامًا كأساس لاتخاذ قرارات حكيمة. فمثلاً، في سياق التعامل مع الأسلحة، إذا كنت غير متأكد مما إذا كان السلاح محشوًا بالذخيرة أم لا، يجدر بك افتراض أنه كذلك والتحقق منه بعناية قبل استخدامه.
- في العديد من الحالات، يُعد منطقيًا الانتقال من حقيقة عدم اكتشاف شيء ما إلى الاستنتاج بأنه غير موجود، خصوصًا إذا كانت الجهود المبذولة في البحث جادة ومعمقة. مثلاً، عندما تختبر أدوية جديدة للتأكد من عدم سميتها، يُعتبر عدم وجود دليل على سميتها خلال الاختبارات دليلاً على سلامتها للاستخدام البشري.
- في دراسات التاريخ، تُستخدم أحيانًا حجج تُعرف بحجج الصمت، حيث يُستنتج من عدم وجود دليل على شيء ما أنه لم يحدث. على سبيل المثال، لا توجد أدلة تُظهر أن الرومان كانوا يمنحون الأوسمة لأشخاص بعد وفاتهم، مما يدعونا للاعتقاد أن هذا لم يكن مُمارسة شائعة لديهم.
- في الأبحاث العلمية، يُطلق على الأدلة التي لا تُظهر حدوث نتيجة متوقعة بعد التجارب اسم “الأدلة السلبية”، وعلى الرغم من أن هذه الأدلة تُعتبر ذات قيمة، إلا أن الدراسات التي تُظهر نتائج إيجابية تُفضل عادةً في النشر العلمي، ما يُظهر نوعًا من التحيز نحو النتائج الإيجابية.
- في مجال تكنولوجيا المعلومات والعلوم الاجتماعية، يُعرف الاستنتاج القائم على عدم المعرفة باسم “الاستدلال بناءً على نقص المعلومات”، حيث يُستنتج بناءً على عدم وجود معلومة في قاعدة بيانات أن الفرضية المتعلقة بها خاطئة. على سبيل المثال، عندما يُطلب من برنامج حاسوبي معرفة ما إذا كانت دولة ما تنتج المطاط، فإن البرنامج قد يستنتج أنه بما أن الدولة غير مدرجة في قاعدته البيانية كمنتجة للمطاط، فمن المحتمل أنها لا تنتجه.
مبدأ الاكتمال المعرفي
لنفترض أنني أعلنت: “المحطات التي يتوقف عندها هذا القطار السريع تشمل القاهرة، بنها، طنطا، دمنهور، والإسكندرية”. من هذا البيان، يمكنني أن أستخلص بأن القطار لا يتوقف في كفر الدوار؛ وذلك لأن هذه المدينة لم تُذكر ضمن قائمة المحطات. هذا يُعطينا فرضية أن قاعدة البيانات المُستخدمة هنا شاملة ومكتملة (مغلقة من الناحية المعرفية)، ويعني ذلك أنه لو كانت هناك محطات أخرى لتوقف القطار لكانت قد ظهرت في القائمة المعلنة. يقوم مبدأ “الاكتمال المعرفي” على فكرة أن “إذا كانت ‘س’ حقيقية لكنت أعرفها” أو “طالما أنني أعرف أنه لا يمكن أن تكون ‘س’ حقيقية دون علمي، فمن عدم ظهور ‘س’ أستنتج أن ‘س’ غير صحيحة”، أو “إذا كانت ‘س’ صحيحة لكانت قد ظهرت في قاعدة بياناتي، وبما أن ‘س’ لم تظهر، فإن ‘س’ غير صحيحة”.
مثال آخر على الاكتمال المعرفي يمكن ملاحظته في قوائم الناجحين بالامتحانات، التي تُعتبر مكتملة معرفيًا. لذلك، الشخص الذي لا يجد اسمه في القائمة يُعتبر راسبًا بالضرورة؛ لأنه لو كان ناجحًا لتم إدراج اسمه بالقائمة.
مفهوم الاستدلال المبني على القرائن
من الجدير بالذكر أن المفهوم العملي للانغلاق المعرفي ليس مطلقًا دائمًا، ومع ذلك، يبقى للاستدلال المبني على القرائن مكانته في عملياتنا العقلية اليومية، مثلما في حالة “برنامج التدريس”، حيث لا نكف عن استخدام الاستدلال في حياتنا اليومية التي تتطلب تفكيرًا عمليًا. نحن نعتمد على أساليب متنوعة في الاستدلال تبعًا للأهداف العملية التي نسعى لتحقيقها، بدرجات مختلفة من اليقين.
أحد هذه الأساليب هو “الاستدلال المبني على القرينة”، وهو تعبير يقع بين الإقرار بالحقيقة والافتراض البسيط. يعتبر هذا النوع من الاستدلال مقبولًا عمليًا لأنه يسمح لنا بالاستنتاج المؤقت للحقائق بناءً على معطيات معينة في الظروف العادية، كأن نقول مثلاً: “من يغيب عن الأنظار لأكثر من سبع سنوات دون تفسير يُعتبر متوفيًا، إلى أن يثبت العكس”. وهذا يعني أن الاستنتاج يتمتع بوجاهة أولية تظل صامدة حتى يُثبت العكس.
يعتمد الاستدلال المبني على القرينة على مبدأ أساسي في القانون يُعرف بعبء الإثبات، حيث ينقل هذا الاستدلال عبء الإثبات إلى الطرف المقابل. فمثلاً، الدواء الذي لم يُظهر سمية للقوارض يُعتبر آمنًا للبشر بشكل مبدئي حتى يُثبت العكس. هذه الفكرة تُساعدنا في تسريع العلاجات دون الانتظار لنتائج طويلة الأمد، ما لم يظهر دليل جديد ينقض ذلك.
وفي المواقف الأخلاقية العاجلة، نُطبق مجموعة من القواعد الأخلاقية مثل عدم القتل، الصدق، والحفاظ على الأسرار. هذه القواعد تبقى سارية حتى تظهر حجة مقنعة تُبرر خرقها. على سبيل المثال، القاعدة الأخلاقية التي تحظر الكذب تظل نافذة ما لم تظهر ظروف تبرر الكذب، وعندئذ يقع عبء الإثبات على من يكذب لتبرير فعله.
أما في المحاكم، فعبء الدليل يقع على الادعاء في القضايا الجنائية، حيث يتوجب على الدفاع فقط إظهار الثغرات في حجج الادعاء وليس إثبات براءة المتهم. وفي القضايا المدنية، يجب على المدعي تقديم الدليل الكافي لدعم دعواه، كما في حالة شخص يدعي أن مؤسسة للغسيل الجاف فقدت بذلته. هنا، يجب عليه تقديم إيصال استلام كدليل، وفي حالة عدم وجود الإيصال، يسقط الادعاء لعدم كفاية الأدلة.