مغالطة المصادرة على المطلوب والتي تُعرف أيضا بمغالطة الاستدلال الدائري أو مغالطة إلتماس السؤال. ويمكننا أن نستنتج من اسم المغالطة أنها قائمة على تأكيد الحجة من الحجة نفسها، حيث يستنتج مرتكب هذه المغالطة استنتاجا من الإدعاء نفسه، دون إضافة أية حجة صحيحة ـ منطقيا. بعبارة أخرى، نبني حجتنا على أساس أن النتيجة التي نريد الوصول إليها صحيحة بالفعل، مما يعني أننا نستخدم النتيجة كأساس لإثبات نفس النتيجة. هذا الأسلوب يُعتبر بمثابة خطأ منطقي لأنه يفتقر إلى البرهان الحقيقي ويعتمد على تكرار الفكرة بدلاً من تقديم دليل جديد.
من الضروري أن نفهم أن البرهان الصحيح يجب أن يكون أكثر وضوحًا وثقة من الفكرة التي يُراد إثباتها. عندما نواجه خلافًا حول مسألة ما، من المفترض أن نلجأ إلى حجج وأدلة لا خلاف عليها لنستند إليها في إثبات وجهة نظرنا. فالحجة القوية يجب أن تنطلق من مقدمات معترف بها ومقبولة لدى الجميع لتقودنا إلى استنتاجات جديدة لم تكن معروفة أو مقبولة مسبقًا.
إن الوقوع في فخ مغالطة المصادرة على المطلوب والاعتماد على النتيجة المراد إثباتها كأساس للحجة، يُعد نوعًا من الاستدلال العبثي والدائري الذي لا يؤدي إلى أي تقدم حقيقي في معرفتنا. هذا النوع من الاستدلال يدور في حلقة مفرغة، حيث يحاول مرتكب المغالطة إثبات فكرة ما بالاستناد إلى مقدمات مفروضة مسبقًا تحتوي على النتيجة نفسها.
تتجلى مغالطة المصادرة على المطلوب في مجموعة متنوعة من الصور والأشكال، بعضها قد يكون خفيًا لدرجة أن فقط الخبراء في المنطق يمكنهم التعرف عليه، والبعض الآخر يكون ظاهرا وواضح، لدرجة أننا غالبا ما نكتشف هذه المغالطة في حديثنا العام دون أن ندرك أنها مغالطة في المنطق. تأتي هذه المغالطة بأشكال عديدة وتختبئ أحيانًا في أماكن لا يسهل العثور عليها إلا على يد من لديهم فهم عميق بعلم المنطق.
أمثلة عن مغالطة المصادرة على المطلوب
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للمصادرة على المطلوب هي عندما تصاغ المقدمة بطريقة تعكس ببساطة النتيجة التي يُفترض إثباتها. على سبيل المثال، قد يُقال إن العدالة تستلزم أجورًا عالية بناءً على أنه من العدل أن يكون للناس القدرة على كسب المزيد من المال. هذا لا يعدو كونه تكرارًا للفكرة نفسها بصيغة مختلفة، دون تقديم دليل حقيقي يدعم الادعاء.
من أكثر الأمثلة شيوعا على مغالطة المصادرة على المطلوب هي عندما تصاغ مقدمة الجملة أو الفكرة بطريقة تعكس ببساطة النتيجة التي يُفترض إثباتها.
مثال: “يجب أن نحافظ على الغابات ولا نقوم بقطع الأشجار لأن تدمير الطبيعة خطأ.”
قد تبدو هذه الجملة من الوهلة الأولى إدعاءً معقولا، لكن في الحقيقة، إذا أمعنا النظر، فسنرى أن قائل هذا الإدعاء لم يأتي بأي جديد، فهو فقط يعيد تقديم الفكرة الأساسية بطريقة مشابهة، إذ تبدو للمتلقي على أنها حُجّة.
لنقم بتحليل الجملة:
“تدمير الطبيعة” = “قطع الأشجار”.
“خطأ” = “يجب ألا نفعل”.
“الحفاظ على الغابات” = معارضة “قطع الأشجار”.
وبهذا التحليل نكتشف أن الحجة في الأساس تقول: “قطع الأشجار خطأ لأن قطع الأشجار خطأ”، مما يجعل الحجة دائرية ولا تقدم دليلًا حقيقيًا أو مبررًا مستقلًا يدعم الاستنتاج.
مثال آخر يتعلق برفض استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم بحجة أنها تشتت انتباه الطلاب وأنه لا ينبغي تخصيص ميزانية لها. الحجة هنا تعيد صياغة الفكرة الأساسية دون تقديم دليل يثبت فعليًا أن التكنولوجيا تشتت الانتباه، وتقوم ببساطة بتكرار الاستنتاج في المقدمات دون تحليل مستفيض للفوائد المحتملة أو دراسة الأدلة التي قد تدعم استخدام التكنولوجيا في التعليم.
كذلك، الادعاء بأن أي شيء أقل كثافة من الماء سيطفو عليه يعتمد على فرضية بديهية، لكنه يتجاهل الحاجة إلى تقديم تفسير علمي يدعم هذا الاستنتاج بوضوح.
وفي حالة القول “إذا لم أكذب، إذًا أنا أقول الحقيقة”، نجد أن العبارة تبسط المعادلة إلى درجة إغفال الاعتبارات الأخرى التي قد تؤثر على مدى صدق الادعاء أو كذبه.
في جميع هذه الأمثلة، يَكمُن التحدّي في كشف أو تجنب مغالطة المصادرة على المطلوب، مما يتطلب تفكيرًا نقديًا وتحليلًا دقيقًا للحجج لضمان الوصول إلى استنتاجات موثوقة ومدعومة بأدلة حقيقية.
صعوبة مغالطة المصادرة على المطلوب
قد يظن القارئ الذي لا يملك خبرة كافية أن فكرة مغالطة المصادرة على المطلوب هي خطأ بسيط وسهل الكشف، معتقدًا أنه لا يستحق الكثير من العناء لفهمه أو تحليله. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك، خصوصًا عندما نعلم أن حتى عقلًا كبيرًا مثل أرسطو، الذي يُعد الأب الروحي للمنطق الصوري، قد وقع في هذا الفخ. فقد أشار جاليليو إلى خطأ أرسطو حين حاول إثبات أن مركز الأرض هو مركز العالم، مستخدمًا حجة تقوم على ملاحظة أن الأجسام الثقيلة تتجه نحو مركز الأرض، والأجسام الخفيفة تبتعد عنه، دون إثبات أن هذا المركز هو بالفعل مركز العالم.
تكمن الصعوبة أيضا في صياغة حجج موضوعية بعيدة عن التأثيرات الأيديولوجية أو العاطفية، مما يفسر قدرة السياسيين على تضليل الناس بسهولة، مستخدمين حججًا مبنية على مغالطة المصادرة على المطلوب. هذه الحجج غالبًا ما تعتمد على فرضيات عامة لدعم قضايا محددة، دون إدراك أن القضية المحددة هي مجرد جزء من تلك الفرضية العامة.
على سبيل المثال، الحجة التي تقول إنه لا يجب الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية لأن الطاقة النووية ليست مصدرًا مستدامًا للطاقة، تعيد صياغة النتيجة داخل المقدمة دون تقديم أدلة علمية أو تحليل للمخاطر والفوائد المرتبطة بالطاقة النووية مقارنةً بمصادر الطاقة الأخرى.
أمثلة أخرى
إن الحجج التي تتعلق بالقضايا الأيديولوجية والأخلاقية هي أكثر عرضة لارتكاب مغالطة المصادرة على المطلوب، خصوصًا لأنها تُوجّه بشكل أساسي إلى من يُشكّكون فيها وتناقش موضوعات تفتقر غالبًا إلى الدليل الواقعي. اللغة المستخدمة في هذه الحجج غالبًا ما تكون محملة بالافتراضات والنظريات، مما يجعلها أدوات جاهزة للاستخدام في المناقشات والجدالات، خاصة عندما يكون الهدف هو إقناع الآخرين بما يجب فعله أو تصديقه. هذه الألفاظ تبدو وكأنها تصف وقائع محضة، لكنها في الواقع تحمل ضمنيًا ما ينبغي أن يكون، مما يجعل الخدعة تكمن في تقديمها كحجج منطقية.
الآن أمثلة أخرى عن هذه المغالطة من مواضيع مختلفة، حيث تُبنى الحجج دائما على استدلال دائري بإعادة الحجة نفسها بكلمات وألفاظ مختلفة دون تقديم أي دليل جديد:
- حظر تصدير الأسلحة: يُطرح أنه لا يجب تصدير الأسلحة إلى ماليزيا لأن توزيع أدوات القتل على الدول يُعد خطأ. هذه الحجة تعيد فقط صياغة الاستنتاج بألفاظ مترادفة دون تقديم أسباب جديدة تدعم الرأي المطروح.
- التجارة الحرة: يُقال إن التجارة الحرة ستعود بالنفع على البلاد لأنها تزيل العوائق أمام تدفق البضائع بين الدول، مما يجلب منافع متعددة. هذه الحجة تدور حول نفسها، حيث تستخدم “التجارة الحرة” و”العلاقات التجارية غير المقيدة” كمرادفين، معيدةً صياغة الاستنتاج دون تقديم دليل ملموس.
- السرقة والقانون: القول بأن السرقة فعل غير مشروع لأن القانون يحرمها يعيد فقط صياغة الاستنتاج. هذه الحجة لا تبين الأسباب الأخلاقية أو الاجتماعية وراء تجريم السرقة، بل تكتفي بالقول بأنها غير مشروعة لأنها غير مشروعة.
- التلباثي: يُردد أن التلباثي ليس حقيقيًا لأن انتقال الأفكار مباشرة بين الأشخاص مستحيل. هنا، “التلباثي” و”الانتقال المباشر للأفكار” يُستخدمان كمرادفين في حجة تفتقد للدليل العلمي القاطع.
- حرية التعبير: يُعتبر أن منح الناس حرية التعبير المطلقة يصب في مصلحة الدولة لأن الحرية الكاملة في التعبير تعود بالنفع على المجتمع. هذه الحجة تصادر على النتيجة دون استكشاف كيف تؤدي حرية التعبير إلى فوائد ملموسة للدولة والمجتمع.
- القتل الرحيم: يُنظر إلى القتل الرحيم على أنه مقبول أخلاقيًا لأنه يساعد الأشخاص على تجنب الألم والمعاناة من خلال الموت، وهو ما يُعتبر عملاً من أعمال الرحمة واللطف. هذا التبرير يدور حول نفسه، مستخدمًا مرادفات لإعادة صياغة الاستنتاج دون التطرق إلى الجدل الأخلاقي الأوسع.
- الإجهاض: يُعرف الإجهاض بأنه قتل غير مبرر لكائن إنساني، وبالتالي، يُعتبر جريمة. هذه الحجة تعيد صياغة الاستنتاج داخل المقدمات دون تقديم تحليل عميق للأسباب التي تجعل الإجهاض موضوعًا للجدل الأخلاقي والقانوني.
في جميع هذه الأمثلة، نجد أن الحجج تفتقر إلى العمق والتحليل الكافيين لدعم الاستنتاجات المطروحة، مما يسلط الضوء على أهمية البحث عن دليل حقيقي وتقديم تحليل معمق عند بناء الحجج.
في بعض الحالات، يتجنب الاستدلال الدائري الوقوع المباشر في فخ المصادرة على المطلوب من خلال عدم افتراض صحة الدعوى المراد إثباتها بشكل صريح في المقدمات. بدلاً من ذلك، يُفترض شيء آخر، قائم صحته على صحة النتيجة نفسها، بمعنى أن البرهنة عليه متوقفة على النتيجة التي يُفترض إثباتها. هذا يُنشئ نوعًا من الدوران في دائرة مغلقة، حيث تعتمد كل دعوى على الأخرى بطريقة مترابطة، مما يُنتج استدلالًا لا يخرج بنا من نقطة البداية.
يُمكننا توضيح هذا الشكل من الاستدلال ببساطة كالآتي:
- الدعوى “أ” صحيحة لأن الدعوى “ب” صحيحة.
- والدعوى “ب” صحيحة لأن الدعوى “أ” صحيحة.
هكذا، نواجه شكلاً من أشكال المصادرة يعتمد فيه البرهان على نفسه، مما يجعل كل دعوى تعتمد على الأخرى دون تقديم دليل حقيقي مستقل عن الدعوى ذاتها. ويمكن أن تتسع هذه الدائرة لتشمل دعاوى أخرى، بحيث تعتمد كل دعوى على التي تليها والأخيرة تعتمد بدورها على الأولى، مكونة دائرة مغلقة دون أدلة خارجية مستقلة.
الاستدلال الدائري يُعد مغالطة لأنه لا يوفر أدلة مستقلة خارج نطاق الدعوى المراد إثباتها، ولا ينجح في ربط المعلومات غير المعروفة أو غير المقبولة بالمعلومات المعروفة والمقبولة. هذا النوع من الاستدلال لا يساهم في توسيع معرفتنا أو فهمنا للواقع، بل يُبقينا في حلقة مفرغة من التبريرات التي لا تستند إلى دليل ملموس.
لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة التي توضح كيف يمكن أن يتخذ الاستدلال شكلاً دائريًا، مما يؤدي إلى تكرار الفكرة بدلاً من تقديم برهان حقيقي:
- يُقال إن الروح خالدة لأنها لا تتأثر بالتحلل أو الفساد، نظرًا لكونها جوهرًا بسيطًا لا ينقسم. وبالمقابل، يُعتبر أن الروح يجب أن تكون خالدة بما أنها جوهر بسيط. هذا التبرير يعيد نفس الفكرة بصورة معكوسة دون تقديم دليل مستقل يثبت الخلود أو البساطة.
- عندما يدعي طالب أنه لم يرتكب فعلًا معينًا، مستشهدًا بضمان زميله لصدقه، ويُعاد السؤال عن سبب الثقة في زميله، يجيب الطالب بأنه هو نفسه يضمن لصدق زميله. هذا يُظهر دائرة من الثقة المتبادلة بدون أساس ملموس للصدق.
- الإيمان بصفات الخالق وطبيعته يُستمد من الكتب المقدسة، ويُبرر الثقة المطلقة في هذه الكتب بكونها موحى بها من الرب نفسه. هذه الحجة تعتمد على الاستنتاج لتبرير المقدمة، مما يُشكل استدلالًا دائريًا.
- يُطلب من شخص تنفيذ مهمة معينة بناءً على تقدير لكفاءته، وعند السؤال عن سبب هذا التقدير، يُجاب بأن طلب تنفيذ المهمة نفسه يُعد دليلاً على التقدير. هذا النوع من التبرير يعتمد على الاستنتاج في تأكيد المقدمة.
- في موقف تقاسم الغنائم، يُبرر شخص أخذ نصيب أكبر بكونه القائد. وعند التساؤل عن سبب كونه القائد، يُرد بأنه يملك نصيبًا أكبر من الغنائم. هذا النقاش يُظهر تبرير الدور والمكانة بناءً على النتيجة التي هي في الأساس محل النقاش.
هذه الأمثلة تُظهر كيف يمكن للاستدلالات أن تدور حول نفسها، معتمدة على مقدمات ونتائج تتبادل الأدوار دون تقديم برهان خارجي يُعزز صحة الدعوى.
هل يُعتبر كل استدلال يدور في حلقة مفرغة خاطئًا بالضرورة؟
عند تحليل الحجج الاستنباطية، نجد أن استخدام النتيجة نفسها كمقدمة (أي “إذا ق، إذًا ق”) يُمكن أن يكون صحيحًا من الناحية الاستنباطية. فأين يكمن الخطأ بالتحديد، ومتى تُصبح هذه الحجة خطأً منطقيًا؟ إذا استعرضنا أفكار أرسطو، الفيلسوف العظيم، سنجد أنه قدم نظرة معمقة حول هذه المسألة، موضحًا أن البرهان يجب أن ينطلق من معلومات أكثر يقينًا ووضوحًا. الخطأ يحدث عند محاولة إثبات دعوى غير واضحة بمجرد افتراض صحتها منذ البداية، ما يُعد تجاوزًا للأسس المنطقية التي تفترض أولوية المقدمات على النتائج.
أرسطو يتناول هذه القضية من زاويتين: في تحليله للبرهان، يرى أن افتراض النتيجة كمقدمة يُعد خطأً ينتهك المبادئ الأساسية للمعرفة. بينما في النقاشات الجدلية، يُعتبر الاعتماد على النتيجة كمقدمة طلبًا غير منطقي من الخصم لقبول ما يُفترض إثباته. هنا، يُقدم أرسطو خمسة أساليب يمكن أن تُستخدم في الاستدلال الدائري، موضحًا أن تقييم هذه الحجج يختلف بناءً على السياق: سواء كان برهانيًا أو جدليًا.
يبدو أن الفارق الرئيسي في تحديد ما إذا كانت الحجة الدائرية صحيحة أو خاطئة يكمن في السياق الذي تُستخدم فيه. السياق الجدلي يحدد كيفية تفسير وتقييم الحجة، فضلًا عن الالتزامات الاعتقادية للمتحاورين. من هنا، يجب التمييز بين دلالة الألفاظ واستخدامها في التواصل البشري، كما فعل أرسطو بتمييزه بين السياقات البرهانية والجدلية.
تُعرف الدلالة بأنها دراسة العلاقة بين العلامات اللغوية والواقع، بينما التداولية تبحث في كيفية استخدام اللغة بين الناس، متجاوزة الدلالة المباشرة للكلمات. من المهم فهم كيف
يُمكن للغة أن تُستخدم لتحقيق أهداف مختلفة في التواصل، من الأفعال الكلامية إلى الإيحاءات الحوارية.
الحجج الدائرية، إذًا، لا تُعتبر خاطئة بشكل مطلق، بل يعتمد تقييمها على السياق الحواري والالتزامات الاعتقادية للمشاركين في النقاش. هذه الحجج تُعد “مغالطات تداولية” عندما لا تُغير في درجة القناعة لدى الطرف المعارض بخصوص النتيجة المطلوب إثباتها، ما يعني أن صحتها أو خطأها يتوقف على التأثير الذي تحدثه في المتلقي وعلى الأساس الذي يبني عليه موقفه.
هل يمكن اعتبار كل استدلال يدور حول نفسه بأنه خطأ منطقي بالضرورة؟ في الواقع، إذا تمعّنا في الحجج الاستنباطية، نجد أن القضية التي تقول “إذا ق، إذًا ق” قد تكون صحيحة في بعض الأحيان من الناحية النظرية. فأين يكمن الإشكال إذًا؟ ومتى تُصبح الحجة المبنية على هذا الأساس مغالطة فعلية؟
لو أخذنا في الاعتبار تعليمات أرسطو، الفيلسوف اليوناني القديم، نلاحظ أنه عالج مسألة المصادرة على المطلوب بطريقة تفصيلية. في أعماله، يبين أرسطو أن البرهان يجب أن ينطلق من حقائق أكثر وضوحًا ويقينًا. الخطأ يحدث عندما نحاول إثبات شيء غامض بمجرد الافتراض المسبق لصحته، مخالفين بذلك القاعدة التي تشدد على أهمية كون المقدمات أوضح وأقوى من النتيجة.
أرسطو يشير إلى هذه المسألة من منظورين: من جهة، يناقش الخطأ في استخدام النتيجة كمقدمة في البرهانات، ومن جهة أخرى، يتطرق إلى استخدامها في النقاشات الجدلية بين طرفين. وفقًا له، تحدث المصادرة عندما يطلب أحد الأطراف من الآخر قبول دعوى معينة كأساس للنقاش، مما يُعد خطأً في هذا السياق.
يتبين من خلال هذا النقاش أن العبرة في تحديد ما إذا كان الاستدلال الدائري خاطئًا تكمن في السياق الذي يُستخدم فيه. يعتمد تقييم الحجة على الالتزامات الاعتقادية للأطراف المشاركة في الحوار.
على سبيل المثال، حجة تؤكد على حفظ النص الديني بدليل من النص نفسه قد تُعتبر مغالطة في حوار مع شخص لا يشاطر نفس الاعتقاد، لكنها قد تُقبل في نقاش بين أشخاص يشتركون في نفس الإيمان. هنا، تظهر أهمية فهم الداعية للجدل وضرورة الانتباه إلى التزامات المخاطب الاعتقادية.
تلك الحجة التي قد تبدو مغالطة في سياق معين، قد تُصبح صالحة ومقبولة في سياق آخر، تبعًا للاختلاف في الالتزامات الاعتقادية بين المتحاورين.
من هنا نستنتج أن المصادرة على المطلوب تُعد مغالطة تداولية، تتوقف صحتها أو خطؤها على كيفية استخدام الحجة في الحوار وعلى مدى تأثيرها في تغيير أو تعزيز موقف المتلقي.
في عمله “نظام المنطق”، يطرح جون ستيوارت مِل فكرة مثيرة للجدل حول الاستدلال الاستنباطي، حيث يعتبر أنه في جوهره ينطوي على مغالطة “المصادرة على المطلوب”. وفقاً لمِل، القياس، وهو أداة منطقية تقليدية، يخفي داخله هذه المغالطة لأن المقدمة الرئيسية فيه تقوم بالفعل على افتراض نتيجة القياس. يُشير مِل إلى القياس الشهير الذي ينتهي بنتيجة أن أفلاطون مثل كل البشر، فانٍ. ويوضح أن المقدمة التي تعمم الفناء على جميع البشر تستند إلى الاعتقاد بفناء أفلاطون نفسه، وهو ما يعني أن القبول بالمقدمة يتطلب الإيمان المسبق بصحة النتيجة.
يساعدنا هنا مفهوم “السياق التداولي” في فهم هذه المغالطة، ويُطرح السؤال: هل يوجد فعلاً دوران منطقي في هذا القياس؟ الإجابة تعتمد على ما إذا كانت هناك أدلة مستقلة، ربما عن طريق الاستقراء، تدعم المقدمة الرئيسية “كل إنسان فانٍ” بمعزل عن النتيجة. هذه الأدلة قد تكون، على سبيل المثال، بينات بيولوجية تثبت فناء الكائنات الحية، مما يُثير تساؤلات عميقة حول دور الأدلة الخلفية في تشكيل سياق الحجة، ويعيدنا إلى التساؤل حول ما يُمكن اعتباره فعلياً “مقدمة” لحجة محددة.
مِل، من خلال نقده هذا، يدعونا للتفكير العميق حول الأسس التي نبني عليها استدلالاتنا الاستنباطية، ويُبرز الحاجة لتقييم دقيق للسياقات التي ننشئ فيها حججنا والأدلة التي نستند إليها.
في كتابه “نظام في المنطق”، يعتقد جون ستيوارت ميل أن الاستدلال الاستنباطي يقع غالبًا في فخ مغالطة المصادرة على المطلوب، حيث يظن أن القياس يشكل دائرة منطقية بإفتراضه صحة النتيجة ضمن المقدمات. يستشهد مِل بالقياس الكلاسيكي الذي يستنتج فناء أفلاطون من كونه إنسانًا، مؤكدًا على أن المقدمة الكبرى في القياس تتطلب قبول النتيجة مسبقًا لإثبات صحتها.
من جانب آخر، يُقدّم مفهوم “السياق التداولي” فهمًا لتقييم هذه المغالطة، حيث يتوقف الأمر على ما إذا كانت هناك بيّنة مستقلة تدعم المقدمة الكبرى بغض النظر عن النتيجة. يُثير هذا النقاش تساؤلات حول ما يُعتبر مقدمة في الحجة، ما يُبرز أهمية الأدلة الخلفية في تشكيل سياق الحجة.
إلى جانب ذلك، يُقدّم مِل أمثلة أخرى على الاستدلال الدائري:
أ) “الخطة القومية” في بريطانيا (1964-1970)، والتي كانت تهدف للتخطيط الاقتصادي القومي. الخطة استندت إلى تقديرات الشركات لمعدل النمو، والتي عند جمعها أكدت الهدف المنشود بمعدل نمو 3.8%، مما يُظهر دوران الحجة في دائرة منطقية دون قيمة حقيقية.
ب) “الدور الديكارتي”، حيث بدأ ديكارت فلسفته بالشك في كل شيء حتى توصل إلى يقين الفكر “أنا أفكر فأنا موجود”. ديكارت استخدم الفكر لإثبات وجود الله كضامن لمعرفته، مما يُظهر دورانًا منطقيًا في استدلاله.
ج) “التحليل النفسي”، حيث تزخر كتابات فرويد وتلاميذه بالاستدلالات التي تفترض صحة ما تحاول إثباته. يُظهر فرويد في “تفسير الأحلام” كيف يمكن للحلم أن يُعتبر تحقيقًا لرغبة، معتمدًا على تفسيرات تؤكد نظريته بطريقة دائرية.
هذه الأمثلة تُبرز كيف يمكن للحجج أن تُبنى على أسس دائرية تفترض صحة ما تسعى لإثباته، مما يطرح تحديات حول صحة الاستدلال وموضوعية التفسيرات في سياقات مختلفة.
تناولت النقاشات حول “تفسيرات تحصيل الحاصل”، وهي تلك الأفكار التي تدور حول نفسها دون إضافة جديدة أو معلومة مفيدة. “تحصيل الحاصل” هو مصطلح يشير إلى العبارات التي تكون صحيحة بطبيعتها اللغوية ولكنها فارغة من المعنى الإضافي، مثل قولنا “إما أن يكون الجو ممطرًا أو ليس ممطرًا”. على الرغم من صحة هذه العبارات، إلا أنها لا تقدم معلومات جديدة أو معرفة حقيقية.
مثال على ذلك، النقد الموجه للتخطيط الاقتصادي في “الخطة القومية” ببريطانيا (1964-1970)، حيث اعتمدت الحكومة على تقديرات النمو من الشركات لتستنتج نفس معدل النمو المُستهدف، مما يُظهر استخدام مغالطة في التفكير دون إضافة قيمة حقيقية.
أيضًا، ناقشنا “الدور الديكارتي” حيث بدأ ديكارت بالشك في كل شيء ليصل إلى نتيجة تؤكد وجود الذات من خلال الفكر. ثم استخدم هذا اليقين لإثبات وجود الله، مما أدى إلى دوران منطقي في الاستدلال لا يخرج بنا من دائرة الشك الأولية.
وفي مجال التحليل النفسي، نجد أن كتابات فرويد تحتوي على استنتاجات تُعيد تأكيد النظريات المسبقة دون تقديم دليل جديد، مثل تفسير الأحلام بأنها تحقيق لرغبة بمجرد أن الحلم يُظهر الرغبة في أن يكون فرويد مُخطئًا.
تُظهر هذه الأمثلة أن الكثير من الفكر العلمي والفلسفي يمكن أن يقع في فخ تقديم “تفسيرات تحصيل حاصل”، والتي تُعيد صياغة المعروف بدلاً من اكتشاف الجديد. ومن المهم التمييز بين الاعتقاد بفكرة والقدرة على تبريرها بأدلة واقعية، لتجنب الوقوع في مغالطة المصادرة على المطلوب والتي تُعد تحديًا خاصًا في المجالات الأيديولوجية والأخلاقية. يُشدد هذا النقاش على ضرورة البحث عن أدلة مستقلة وتجنب الاعتماد على الدعوى نفسها كبرهان، لضمان بناء حجة منطقية ومستدامة.


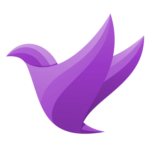
التعليقات
Loading…