في هذه الحكاية الطريفة، يستعد جحا للزواج ويشرع في بناء منزل يسعه وأسرته. يطلب من النجار تنفيذ تصميم غريب حيث يجب أن توضع أخشاب السقف على الأرض، وأخشاب الأرض على السقف. النجار، مذهولًا، يستفسر عن السبب وراء هذا الطلب العجيب، فيجيبه جحا قائلاً: “ألم تدرك بعد أن المرأة تمكن من قلب الأمور رأسًا على عقب حين تدخل مكاناً؟ فلنقلب الغرف الآن لتصبح متوازنة بعد الزواج.” في هذه المفارقة، يلعب جحا باللغة ليصور مغالطة نقع فيها جميعاً، حيث نستسلم لتقبل الأمور بشكلها الأبسط والأكثر خفاءً، دون تساؤل.
تعكس هذه القصة مفهوم “التجسيد” أو الأَقنَمَة، وهي عملية تعاملنا مع المفاهيم المجردة كما لو كانت كائنات مادية. نحن، كبشر، نبدع في خلق مفاهيم عقلية تساعدنا على فهم وتبسيط الأشياء والأحداث، مما يوفر لنا وفرة ذهنية. ومع ذلك، تتمثل المأساة في أننا أحياناً نعامل هذه المفاهيم كما لو أنها موجودة فعليًا، ما يؤدي إلى مغالطات منطقية متأصلة في تفكيرنا.
مغالطة “التجسيد” تعد من أكثر المغالطات شيوعًا وأهمية، وهي تشكل أساسًا لنظريات فلسفية، سياسية، اجتماعية، وعلمية. الفلاسفة لهم الحرية في تحديد ما هو حقيقي، لكن يجب عليهم عدم فرض هذه التجسيدات على مجالات بحثية أخرى، حيث يؤدي ذلك إلى إثارة الاضطراب والخلط. تاريخ العلم والمجتمع والسياسة، وحتى الرياضيات، شهد العديد من الأخطاء الكبرى التي عطلت تقدمها بسبب إصرار المفكرين على تعريفات “حقيقية” تعكس تصوراتهم الخاصة بدلاً من الواقع، مما أدى إلى إنكار مناطق بحثية كاملة بوصفها غير حقيقية أو غير صالحة.
يمتلك مفهوم “التشييء” تطبيقاته الإيجابية في ميدان البيان والبلاغة، حيث يتم استخدامه بوعي ودراية لغرض التعبير الأدبي المكثف من خلال الاستعارات، المجازات، والتشخيصات. هذه الأساليب اللغوية تعتبر أدوات فعالة جدًا في الأدب والشعر، وأحيانًا في العلم نفسه، لما لها من قدرة على إثراء النص وتعميق المعنى بشكل يفوق الوصف المباشر والحرفي.
صحيح أن “التشييء” قد يُصبح مغالطة حين يُساء استخدامه، فقد يدفعنا للتغاضي عن كون الاستعارات مجرد أدوات تعبيرية ونبدأ بالاعتقاد بأن المفاهيم المجردة التي نصفها لها وجود ملموس. فاللغة التي نستخدمها لوصف الواقع تؤثر بشكل كبير على فهمنا له، مما يستدعي منا الحذر في كيفية توصيفنا للأشياء حتى لا نخلط بين الوصف والواقع.
على سبيل المثال، في حالات مثل البارانويا، يُعاني الأشخاص من اعتقاد بأنهم مضطهدون من قِبل المحيطين بهم. ولكن، بدلاً من فهم “الاضطهاد” كتصور للسلوكيات، يبدأ الشخص المصاب بالبارانويا بتصديق أن هناك “قوة خفية” تدير هذه السلوكيات. في هذه الحالة، “الاضطهاد” ليس مجرد تصنيف لأفعال، بل يُنظر إليه ككيان حقيقي ومستقل، وهو ما يمثل مثالاً على التشييء المغالط.
في ميدان آخر، نجد العرَّافين وزبائنهم يُشيِّئون مفهوم “المستقبل” كما لو كان شيئًا ملموسًا يمكن رؤيته في فنجان أو كرة بلورية. يتم التعامل مع “المستقبل” كمكان مادي يمكن الوصول إليه ورؤية أحداثه المحتملة، وهو ما يُعد تجسيدًا خاطئًا للمفهوم.
من خلال هذا الفهم المتعمق لـ “التشييء”، يمكننا الإدراك أن الطريقة التي نستخدم بها اللغة ليست مجرد أداة للتعبير، بل قد تكون عاملاً حاسمًا في تشكيل وجهات نظرنا واعتقاداتنا. لذا، يجب علينا التفكير بعناية في كيفية توصيفنا للأشياء لتجنب الوقوع في فخ المغالطات الناتجة عن سوء التشييء.
يُعبر هيجل عن الدولة بوصفها تجسيدًا للفكرة الإلهية في عالمنا المعاصر، ويصورها كقوة سامية مطلقة على الأرض، ذات غاية ومقصد خاص بها. في هذا السياق، ينظر إليها كالغاية النهائية التي تتفوق حقوقها على حقوق الفرد.
لكن، على الرغم من إمكانية تفسير كلمات هيجل على نحو استعاري يخلصه من الوقوع في فخ التشييء، إلا أن تفسيرات كثيرة لهذه الكلمات قد انحرفت نحو التشييء بأبشع صوره، وذلك عبر تبنيها من قبل فكر ماركسي أو نازي وأشكال أخرى من الشوفينية. هذه التفسيرات جعلت من الأمة غاية مطلقة تتجاوز رفاهية ومصلحة الفرد، حيث يُنظر إلى الأمة ككائن ضخم يعيش ويتألم ويمرض، ومن أجل مجده يُضحى بالأفراد.
يُعلّق سلفادور دي مادارياجا على هذا المسار بالقول إن الغاية العليا ينبغي أن تكون الفرد نفسه، ولا يجوز للمؤسسات الجماعية أن تملك سلطة عليه إلا للدرجة التي تخدم نموه الشخصي.
في سياق متصل، يتحدث عشاق السيكولوجيا عن “الأنا” و”الهو” كأنهما كيانات بديلة تديران العقل البشري، وهذا يُذكرنا بمفهوم “الشبح في الآلة” الذي ذكره جلبرت رايل ساخرًا من النظرة الثنائية لديكارت.
وبطريقة مماثلة، يُشيّئ الناس غالبًا الحب كأنه كيان شبحي يستحوذ على العاشق ويتحكم فيه. الحب ليس جوهرًا بل علاقة، ليس كائنًا بل تناغم بين كائنين. هذا التشييء قد يدفع العاشق إلى الاستسلام للحب دون بحث عن مخرج، معتقدًا أن الحب قدر لا مفر منه. يعتقد أن الحب قد استوطن قلبه وأصبح جزءًا لا يتجزأ منه، وعندما يحاول أن يقترب من محبوبته واقعيًا، قد يصدم بالواقع الذي لا يطابق المثال الذي بناه في خياله، مما يُذكرنا بقول المتنبي:
مما أضر بأهل العشق أنهم
هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا
تفنى عيونهم دمعًا وأنفسهم
في إثر كل قبيح وجهه حسن
أمثلة
1. “تنفر الطبيعة من الفراغ”، ولكن في الحقيقة، الطبيعة ليست لديها أية مشاعر تجاه الفراغ.
2. “تتسم أهداف الطبيعة بالنبل، وعليه يجب أن نرحب بما تقدمه الطبيعة”، غير أن الطبيعة لا تملك أهدافًا أو نوايا.
3. “القوانين العادلة وحدها هي التي تشفي آلام المجتمع”، متجاهلين أن القوانين لا تعالج، والمجتمعات لا تشعر بألم.
4. “الصناعة تمثل خطرًا على الطبيعة والمجتمع”، لكن الحقيقة هي أن الصناعة ليست كيانًا يقوم بفعل، والطبيعة والمجتمع ليسا أشياء تُفعَل بها، بل بعض الأنشطة الصناعية قد تؤثر سلبًا على جوانب من البيئة أو على أفراد معينين في مجتمع.
5. “كيف يمكن مقارنة الاعتبارات الشخصية بحاجات المجتمع، ومصير الأمة، والحفاظ على الثقافة؟” مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع لا يملك حاجات ملموسة، والأمم ليس لها مصائر محددة، ولا يوجد “شيء” يُدعى “الثقافة” يُحفظ، الاعتبارات الشخصية هي ما يظل موجودًا فعلاً.
تظهر هذه الأمثلة كيف يمكن تفسير المفاهيم مثل “الطبيعة”، “المجتمع”، “الصناعة”، “الأمة”، و”الثقافة” بشكل استعاري ومجازي، ولكن غالبًا ما يخطئ الناس في تجسيدها ككيانات ملموسة، مما يؤدي إلى الوقوع في مغالطات فكرية. في الأيام الأخيرة لهتلر، على سبيل المثال، تحدث عن “الأمة” ككيان حقيقي مستقل، مما يظهر تمثيلًا خاطئًا للأمة كونها يجب أن تكون فوق حياة الأفراد.


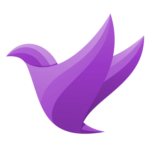
التعليقات
Loading…